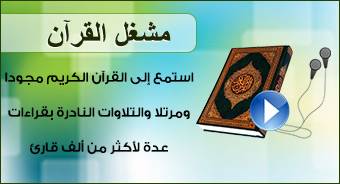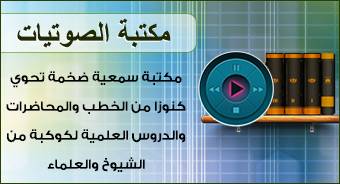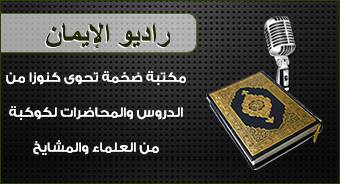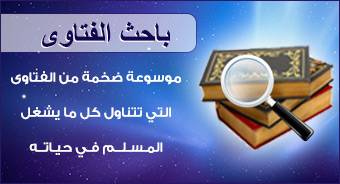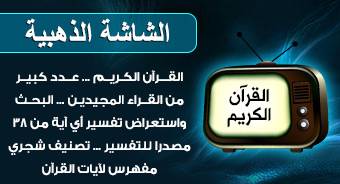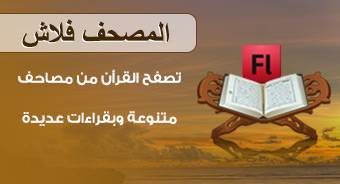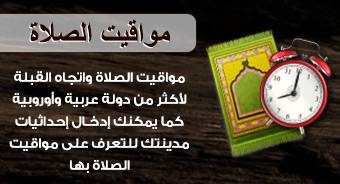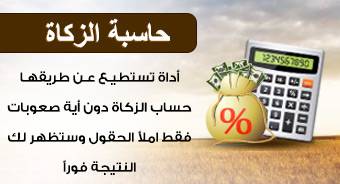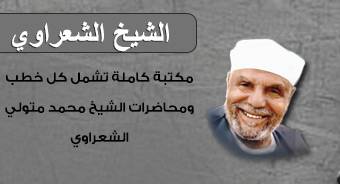|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
[النهاية 1/ 111، والمصباح المنير مادة (بخر) ص 14، والمطلع ص 324، والموسوعة الفقهية 8/ 17- 19].
[التوقيف ص 118].
قال الجرجاني: هو ظهور الرأي بعد أن لم يكن. قال المناوي: هو ظهور الشيء بعد أن لم يكن به. [المصباح المنير (بدا) ص 16، والتعريفات ص 26، والتوقيف ص 118].
[المصباح المنير (بدأ) ص 16، والمطلع 16، 17].
والبدعة: الحدث، وما ابتدع في الدين بعد الإكمال. وفي (لسان العرب): المبتدع الذي يأتي أمرا على شبه لم يكن، بل ابتدأه هو، وأبدع، وابتدع، وتبدع: أتى ببدعة، ومنه قوله تعالى: {وَرَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللّهِ} [سورة الحديد: الآية 27]. وبدّعه: نسبه إلى البدعة، والبديع المحدث: العجيب، وأبدعت الشيء: اخترعته لا على مثال، والبديع: من أسماء الله تعالى، ومعناه: المبدع، لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها. اصطلاحا: الفعلة المخالفة للسّنة. وعرّفها الإمام الشاطبي فقال: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. قال: وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة، وإنما يخصها بالعبادات، وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول: - البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. فائدة: قال في (الدستور): البدعة خمسة أقسام: الأول: واجبة. الثاني: محرمة. الثالث: مندوبة. الرابع: مكروهة. الخامس: مباحة. وذلك أنها إن وافقت قواعد الإيجاب فـ (واجبة)، أو قواعد التحريم فـ (محرمة)، أو المكروه (مكروهة)، أو المندوب (مندوبة)، أو المباح (مباحة). و(المندوبة) كأحداث المدارس والكلام في دقائق التصوف، و(المباحة) كالتوسيع في اللذيذ من المآكل، والمشارب، والملابس، والمساكن. وهؤلاء المتمردون لا يميزون بين هذه الأقسام ويجعلون جميع ذلك من المحرمات، وهل هذا إلّا تعصب وضلالة عصمنا الله تعالى عنه في أمور الدين ورزقنا اتباع الحق واليقين بحرمة سيد المرسلين صلّى الله عليه وسلّم. انتهى. وسمعت من كبار العلماء أن المراد بالبدعة: الكفر، في قولهم: سب الشيخين كفر، وسب الختنين بدعة، وإنما هو تفنن في العبارة. [المغرب ص 37، والاعتصام للإمام الشاطبي 1/ 37، والتعريفات ص 37، وغرر المقالة ص 88، والتوقيف ص 118، 119، والمطلع ص 334، والحدود الأنيقة ص 77، ودستور العلماء 1/ 232].
إحداهما: لها من الأدلة متعلق، فلا تكون من تلك الجهة بدعة. الثانية: ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية. [الاعتصام 1/ 286، 287، والموسوعة الفقهية 8/ 32].
[التوقيف للمناوي ص 119].
وقال صاحب (المطالع) وغيره: البدنة والبدن، هذا الاسم يختص بالإبل، لعظم أجسامها، وللمفسرين في قوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ} [سورة الحج: الآية 36]. ثلاثة أقوال: الأول: أنها الإبل، وهو قول الجمهور. الثاني: إنها الإبل والبقر، قاله جابر رضي الله عنه وعطاء. الثالث: أنها الإبل، والبقر، والغنم. قال البعلي: حيث أطلقت في كتب الفقه، فالمراد بها: البعير ذكرا أو أنثى، فإن نذر بدنة وأطلق، فهل تجزئه البقرة؟ على روايتين، ذكرهما ابن عقيل، ويشترط في البدنة- في جزاء الصّيد ونحوه- أن تكون قد دخلت في السّنة السادسة، وأن تكون بصفة ما يجزئ في الأضحية. قال في (الزاهر): والبدنة: سمّيت بدنة لسمنها وعظمها، يقال: (بدن الإنسان) فهو: بادن، إذا سمن، وبدّن يبدن تبدينا: إذا أسنّ، ويقال للرجل المسن: (بدن)، ومنه قوله: وقيل: (البدنة): اسم تختص به الإبل، إلّا أن البقرة لما صارت في الشريعة في حكم البدنة قامت مقامها، وذلك لما قاله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (نحرنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة) [مسلم (الحج) 138]. فصار البقر في حكم البدن مع تغايرهما لوجود العطف بينهما، والعطف يقتضي المغايرة. [الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 126، وتحرير التنبيه ص 164، والمطلع ص 176، وفتح الباري م/ 90، والموسوعة الفقهية 8/ 41].
والبادى: هو المقيم في البادية، ومسكنه المضارب والخيام ولا يستقر في موضع معين، والبدو: سكان البادية، سواء أكانوا من العرب أم من غيرهم، أما الإعراب: فهم سكان البادية من العرب خاصة، وفي الحديث: «من بدا جفا». [أحمد 2/ 371] أي: من نزل البادية صار فيه جفاء الأعراب، ولا يختلف استعمال الفقهاء عن ذلك. [المعرب ص 37، والكليات ص 243، والموسوعة الفقهية 8/ 45].
[المصباح المنير (بده) ص 16، والكليات ص 248، والتوقيف ص 120].
[المصباح المنير (بذخ) ص 16، ونيل الأوطار 4/ 118].
[المصباح المنير (بذر) ص 16، وطلبة الطلبة ص 20، والموسوعة الفقهية 8/ 49].
وهي في الاصطلاح بهذا المعنى، غير أنه يراد بها: الحراسة في السفر وغيره. [المصباح المنير مادة (بذرق) ص 16، وحاشية ابن عابدين 5/ 44، والموسوعة الفقهية 8/ 50].
وبذل الثوب وابتذله: لبسه في أوقات الخدمة والامتهان. قال ابن القوطية: (بذلت الثوب بذلة): لم أصنه، وابتذلت الشيء: امتهنته، والتبذل: خلاف التصاون. [المصباح المنير (بذل) ص 16، والتوقيف ص 121].
القطع. فالبراءة: قطع العلاقة، يقال: برئت من الشيء، وأبرأ براءة: إذا أزلته عن نفسك وقطعت أسبابه، وبرئت من الدين: انقطع عنّى ولم يبق بيننا علقة. اصطلاحا: قال ابن عرفة: (ترك القيام بعيب قديم). فوائد: 1- في تعريف ابن عرفة: (ترك) مصدر يناسب براءة المشترى، واحترز (بقديم) من الحادث، وقوله: (القيام بعيب): أخرج به القيام لا بعيب كترك الدّين وغيره، فإنه يصدق عليه إبراء عرفا لا براءة عرفية، وقوله: (قديم): أخرج به ترك القيام بالعيب الحادث، فإنه لا قيام له، وليس براءة معهودة شرعية. 2- البراءة في ألفاظ الطلاق: المفارقة، وفي الديون، والمعاملات، والجنايات: التخلص والتنزه، وكثيرا ما يتردد على ألسنة الفقهاء قولهم: (الأصل براءة الذمة): أي تخلصها وعدم انشغالها بحق آخر. وقيل: هي أثر الإبراء، وهي مصدر: برئ، فهي مغايرة له في الفقه، غير أن البراءة كما تحصل بالإبراء الذي يتحقق بفعل الدائن، تحصل بأسباب أخرى غيره: كالوفاء، والتسليم من المدين، أو الكفيل. وتحصل البراءة بالاشتراط، كالبراءة من العيوب، ويعبر بها بالتبرؤ أيضا، وتفصيله في خيار العيب والكفالة. [لسان العرب مادة (برأ)، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 371، وتفسير القرطبي 8/ 63، وتفسير الرازي 16/ 217، والموسوعة الفقهية 1/ 142، 8/ 51].
قال الخطابي: (البراجم): العقد التي تكون في ظهور الأصابع. والرواجب: ما بين البراجم، وواحدة البراجم: برجمة. قال ابن بطال: وهي جمع برجمة، وهي مفاصل الأصابع التي بين الأشاجع والرواجب، وهي رءوس السّلاميات من ظهر الكف إذا قبض القابض كفه، والتي تلي الأنامل: هي الرّواجب، والتي تلي الكف: هي الأشاجع، وإنما خصّها وحضّ على غسلها، لأن الوسخ يلصق بغضونها وتكسّرها، ولا يبلغها الماء إلّا بمعاناة. ومن السّنن العشر: الانتضاح بالماء، وهو أن يأخذ قليلا من الماء فينضح به مذاكيره بعد الوضوء لينفى عنه الوسواس. وقيل: هو الاستنجاء بالماء، وسئل عطاء عن نضح الوضوء؟ فقال: (النضح): النشر، وهو ما انتضح من الماء عند الوضوء. قال في (القاموس): وهي المفصل الظاهر أو الباطن من الأصابع، والإصبع الوسطى من كل طائر، أو هي مفاصل الأصابع كلها، أو ظهور العصب من الأصابع، أو رءوس السّلاميات إذا قبضت كفك نشرت وارتفعت. وقيل: يلحق بها المواطن التي يجتمع فيها الوسخ عادة كالأذن، والأنف، والأظفار، وأي موضع من البدن. [القاموس المحيط (برجم) 1395، وغريب الحديث للبستي 3/ 208، ومعالم السنن 1/ 28، والنظم المستعذب 1/ 24، والتوقيف ص 121، ونيل الأوطار 7/ 50]. |